في الذكرى الثامنة لبيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، تقف المملكة العربية السعودية شامخة على أرض الواقع الجديد الذي صاغه قائد شاب واستثنائي، حمل طموح شعب بأكمله على عاتقه، واستثمر في الإنسان السعودي، وراهن على قدراته، وآمن بأن هذا الوطن العريق والثريّ يملك من الإمكانات ما يضعه في مصاف الدول العظمى.
لم تكن لحظة تولي سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد مُجرّد ترتيب لبيت الحكم وتسهيل تناقل السلطة إلى جيل أحفاد الملك المؤسس؛ بل كانت لحظة ولادة مشروع فكري وتنموي متكامل، قوامه الدولة الحديثة في مفهومها، الفتية في شعبها، القوية بمقدراتها، الفخورة بقيمها وتراثها، المُؤمنة بقيادتها الوطنية والمُعتزّة بريادتها العربية والإسلامية.
منذ اللحظة الأولى، أدرك سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان أن الثروة الحقيقية ليست في النفط، بل في الإنسان السعودي؛ وهو ما عبّر عنه بقوله: «ثروتنا الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت؛ شعبٌ طموحٌ، معظمُه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمانُ مستقبلها بعون الله».
بهذا اليقين، وبهذه الثقة، انطلقت رؤية السعودية 2030، التي لم تكن مجرد خطة تنموية، بل تحوّلت إلى قصة وطنية كبرى، جمعت الطموح بالعزيمة، والإرادة بالتخطيط، والهوية بالحداثة، وأعادت صياغة دور الدولة من الرعوية إلى التمكين والتحفيز.
أعاد سموه الاعتبار لموقع المملكة الديني والثقافي والجغرافي والتاريخي، وعبّر عن ذلك برؤية تستحضر عمقنا الوجداني وثقلنا الاقتصادي، حين قال: «نحن نثق ونعرف أن الله -سبحانه- حبانَا وطناً مباركاً هو أثمن من البترول؛ ففيه الحرمان الشريفان، أطهر بقاع الأرض، وقبلة أكثر من مليار مسلم... وهذا هو عمقنا العربي والإسلامي وهو عامل نجاحنا الأول».
بهذا الإيمان الراسخ، أصبحت المملكة مركزاً عالمياً للنقاشات الكبرى، وموطناً للمبادرات العابرة للحدود، في الاقتصاد والمناخ والتكنولوجيا والثقافة.
في مسيرة سمو سيدي ولي العهد هناك إنجازات لا حصر لها؛ ولكن أكثرها أهمية يتمثل في نجاح سموه في صياغة نموذج سعودي فريد للاستقرار والدبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط التي لطالما عُرفت بالتحولات والانقسامات الحادة. فقد قدّم سموه نموذجاً جديداً للعقلانية السياسية، لا ينحاز فيه إلا لمصالح بلاده، ولا يتخلى فيه عن دورها القيادي.
المملكة اليوم حاضرة في كل الملفات الدولية الكبرى، من أوكرانيا إلى الملف النووي الإيراني، مروراً بالوساطة في تبادل الأسرى، والعلاقات المتوازنة مع القوى العظمى، وصولاً إلى اتفاق بكين بين السعودية وإيران، الذي شكّل نقطة تحول في المشهد الإقليمي، وأعاد تعريف معادلات النفوذ والمصالح، وعدا ذلك كله موقفها المبدئي والتاريخي من قضية فلسطين التي أكسبها سموه مستوى مختلفاً بالوقوف مع منطق الدولة والقانون الدولي وإنصاف المظلومين.
لم يكن سمو الأمير محمد بن سلمان مُدافعاً عن الأمن السعودي فحسب؛ بل عمل على ترسيخ مكانة المملكة كصانع للتوازن الإقليمي، عبر خطاب دبلوماسي عقلاني يتجاوز الشعارات إلى المسارات الفعلية للتهدئة والبناء. ومن خلال هذا المسار، تمكّنت المملكة من تقليل مخاطر التصعيد مع إيران، وإعادة التموضع كضامن لاستقرار الخليج، وليس مجرد طرف فيه. لقد غادرت المملكة منطق الاستقطاب، نحو صناعة الجسور، وعززت مكانتها كقوة تسعى لا إلى الصدام، بل إلى استثمار نفوذها في ضبط الإيقاع الإقليمي، بما يخدم مصالحها العليا وأمنها واستدامة رؤيتها.
إن ما صنعه الأمير محمد بن سلمان خلال هذه السنوات الثماني ليس مجرد إنجاز تنموي أو نهضة اقتصادية؛ بل هو مشروع حضاري جديد، يعيد للسعودية دورها الريادي كدولة قائدة في العالمين العربي والإسلامي، وشريك استراتيجي فاعل في النظام الدولي. وقد عبّر عن هذه الرؤية بوضوح حين قال: «ما نطمح إليه ليس تعويض النقص في المداخيل فقط، أو المحافظة على المكتسبات والمنجزات، ولكن طموحنا أن نبنيَ وطناً أكثر ازدهاراً يجد فيه كل مواطن ما يتمناه».
وبينما تستمر المملكة في بناء مدنها المستقبلية، وتنويع اقتصادها، وتمكين شبابها، تتعزز مكانتها كصانعة سلام في عالم متوتر، وكشريك موثوق في أزمنة الفوضى، وكقصة نجاح عربية بمعايير عالمية تُلهم الأجيال وتعيد تعريف معاني الطموح، لتبقى السعودية –كما أرادها ولي عهدها ووريث عرشها– دولة تليق بتاريخها، وتستحق مستقبلها.
.png)
.png) منذ ٢ أيام
٢٤
منذ ٢ أيام
٢٤




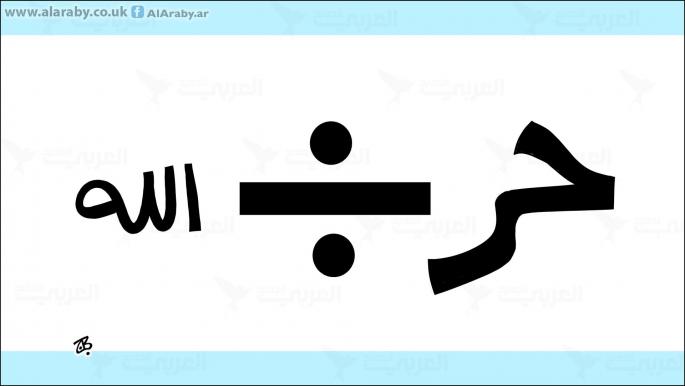



 English (US) ·
English (US) ·