هم شحاذو دمشق، أولادها، مراهقوها، المنتشرون في كل زاوية من زوايا المدينة. لا يترددون في الإمساك بثيابك، ينهَرونك لتمنحهم ما يسدّ رمق جوعهم. أولئك الذين يدهنون أقدامهم الصغيرة الحافية بالوحل المتجمد في برد فبراير/شباط القارس فقط كي يبدو البؤس واضحاً، هؤلاء بين أزقة دمشق القديمة، لن يأكلوك، ولن تلوث قذارتهم ملابسك النظيفة. أولئك الليليون الصامتون الذين يصرخون نهاراً.
بعنادٍ، حاولت أن أفهم حركتهم، أفعالهم، كانوا هوسي لأيام. لدرجة أنهم بدأوا يتساءلون فيما بينهم: من هذه "الخالة اللزقة"؟ من هذه الطفيلية التي تريد تحويل مأساتنا إلى مشهد للفرجة؟ ربما هذا ما نفعله جميعنا، نحن الذين نكتب عن آلام الآخرين دون القدرة على إنقاذهم. إنه عارٌ آخر يُضاف إلى عار البشرية.
تخرج في الليل أصوات بشرية تختلف عن تلك التي نسمعها في عز النهار. لا يبدو أصحابها وكأنهم يبحثون عن شيء محدد، بل هناك غضب وفراغ يهيمنان عليهم. في عيونهم تتقافز انفعالات كثيرة، لكنها تُختصر في اثنين فقط: الفراغ والغضب. الرجاء والتوسل المعتادان يظهران كقشرة رقيقة، يستطيع الرائي، الإنسان الحقيقي، أن يخترقها. حتى الروائي المتوحش، قد يذرف بضع قطرات أمام تلك النظرات المتوسلة المضلِّلة. نعم، هناك فراغ وغضب، لكنك، يا عزيزي، لا تملك الوقت أو الطاقة لفهم كل نظرة على حدة. ولا تنخدع، فنحن حين نتحدث عن "الليليين الصامتين" في دمشق، لا نعني أنهم جماعة متجانسة قابلة للتحليل أو الفهم أو التصنيف. هذه فكرة بائسة، بالية. لا يمكن قياس أي مجموعة بمعايير ثابتة، خاصة في مكان اسمه سورية، أصبح مخيفاً بطريقة عصية على التصديق.
الليليون الصامتون هم أنفسهم أولئك الأشخاص الذين يتغيرون كلياً في النهار. يصرخون، ويركضون، ويزعقون. لكن الليل يسلبهم أصواتهم، إلّا من بقي منهم يزمجر ويسبّ ويشتم بعيون مشتعلة بالحقد والغضب، إلى أن يغلبهم التعب وينامون. هؤلاء جاهزون لتقويض العالم بأسره. ويوماً ما، سيزحفون كالجراد ليبتلعوه.
لنتفق. ليست هذه قصةً عن أطفال الشوارع في دمشق، بل هي محاولة كتابة ضد النسيان، ضد التبسيط، ضد الرواية الرسمية عن الطفولة. لا تلد الحرب أيتاماً فقط، بل تلد مفهوماً جديداً للطفولة؛ طفولة بحذاء مثقوب، تسير على جسد المدينة كأنها تمشي فوق جماجمها، عن البؤس المجرد من ملامحه الإنسانية.
هذا نصٌّ عن الأصوات التي لا تصرخ، عن نظراتٍ تفكك المدينة أكثر مما فعلت القذائف. لا ترتعب، لا تخف وأنت تقرأ هذه الكلمات.
في حي القيمرية
بحكم إقامتي في دمشق القديمة، في حي القيمرية تحديداً، كنت قد راقبت ثلاث مجموعات من "الليليين الصامتين". إحداها تقف عند ساحة باب توما، وأخريان تظهران بعد الانعطافة الأولى يساراً، خلف الساحة مباشرة. لم يكونوا ثابتين كمجموعات، يظهرون أحياناً فرادى، وأحياناً تتغير تركيبتهم، لكنّ مجموعة القِيمرية احتلت المكان الرئيس في دماغي. تتألف من ثلاث فتيات. واحدة بالكاد تتجاوز الثالثة من عمرها، الصامتة الكبيرة رغم صغرها. الثانية في نحو السابعة، والثالثة على مشارف المراهقة، قالت إنها في الثالثة عشرة. كانت الوحيدة التي قبلت أن تعطيني اسماً، عرفت لاحقاً أنه ليس اسمها الحقيقي.
في الطريق إليهن كل ليلة، كانت هناك عجوز. امرأة لا تتوقف عن الكلام والتوسل، وحيدة على كرسي بعجلات. تجلس في الزقاق، تكرر مناشدتها نفسها، تتلقى النقود من المارة. حولها يتحرك أولاد بألسنة حادة، يسبّونها، يختفون، ثم يعودون. كنت أراقبها من بعيد، أرتجف لبردها المرتعش. بعد أن تنال نقودها، يظهر شاب، يقترب منها، يأخذ ما في يدها، تشتمه وتدعو عليه بالموت، وهو يفرّ، بينما الأولاد يتحلقون حوله. كان مشهداً يتكرر بنظام محكم. كلٌّ يعرف دوره. عينا الشاب واسعتان، تراقبان العجوز كما تُراقبان فريسة. ينقضّ، ثم يهرب. تولول، ثم تسكت، ثم تعود. قيل لي إن جماعات كاملة تعمل على تشغيل العجائز والأطفال.
هذه العجوز لم تكن تؤدي دوراً تمثيلياً. كانت فعلاً عاجزة. وجهها تحت ضوء الشارع الأصفر شاحب، تصرخ، تشتم الأولاد الذين يقرصونها، أو يصرخون في وجهها، أو يحاولون انتزاع رغيف من بين يديها. في لحظة ما، يغادر الأولاد، ويبتعد الشاب. يختفي، لا ألمحه. ثم تصمت. تصمت نهائياً بعد منتصف الليل. ثم يعود لا بد أنه هو، في وقت ما من الفجر، يعود الشاب ذاته ليأخذها إلى مكان آخر. في الصباح لا أراها. لكنها تعود دائماً بعد منتصف النهار، لتُوضع في نفس الزاوية، بنفس الحالة، وكأن شيئاً لم يحدث.
لم تجبني يوماً حين خاطبتها، لكنها رغم إعاقتها كانت تشكل منافساً خطيراً للمجموعة القريبة منها. أما البنات الثلاث، فكن وحدهن مع صبي لم يقبل أن يخبرني بعمره، وبدا مدهوشاً من سؤالي. اكتفى بتكرار جملته: "بدي آكول يا خالة". يمكنك، عزيزي القارئ أن تذهب إليه بسندويشة، وسيأخذها. لكنه سيشتمك أيضاً، لأنه لم يحصل على النقود المطلوبة. الشاب الذي يأخذ النقود من العجوز، يطالب الصبي أيضاً بالمال. وإن لم يحصل عليه، يضربه. لقد ضربه مرة، خبط رأسه بالحائط، أمام أعين المارة، الذين واصلوا طريقهم كأن شيئاً لم يحدث. نظرة خاطفة على الرأس المرتطم، ثم مضوا. تشعر للحظة أن لا شيء يمشي للأمام في هذه المدينة، بل يعود إلى الوراء، إلى لحظة ما قبل النطق، حين كان كل شيء يفهم بالبكاء.
في باب توما، لا يتوقف الزحام ليلاً. الشوارع مكتظة، في كل زاوية من زوايا المدينة، طفل يمدّ يده ويسأل، كأن سؤال الحاجة صار جزءاً من مِعمار الشارع، نُقشَ في الحجر مثل كتابات السومريين. محلات بيع الطعام تعج بالزبائن، والأطفال الشحاذون ينبتون هناك كالعشب، عشب طري، عشب يابس، عشب يُداس أو يُنظر إليه بلا اكتراث، ثم يُترك وراء الأقدام.
قررت أن آتي بعد منتصف الليل، أن أبقى وأنتظر، لأعرف متى يرحلون. كانت الليلة من أواخر فبراير/شباط الماضي. في أماكن أخرى من سورية، الناس لا يخرجون بعد الخامسة مساءً، هذا رأيته في اللاذقية وجبلة. لكن دمشق مختلفة.
يتقاتل السوريون على صحة المعلومات. كلٌّ لديه أسبابه. كلٌّ ينتمي إلى "سوريا" مختلفة. ما يُقال في دمشق ليس كذباً، وما يُقال في الساحل ليس كذباً. يتعاركون على الصواب والخطأ، بينما كل واحد يحمل حصته من الحقيقة، وحصته من الأسى، وحصته من العار. لكن في زواريب باب توما، كانت الحياة تمضي مع "الليليين" بطريقة مختلفة.
كنت أقف في الزاوية، أراقب الفتيات الثلاث. عيني على الصغيرة؛ حافية القدمين، ترتدي ثوباً يصل إلى ركبتيها، تحته سروال قصير. قدماها ملوثتان بطين داكن، كأن أحداً دهَنهما بمادة سميكة. الطين نفسه على يديها، وعلى وجهها. القدم الصغيرة النحيلة، والوجه المعفّر بالطين، جعلاها تبدو ككائن خرج لتوه من فيلم، لا من زقاق.
جلست على الأرض المبللة بماء المطر. ثوبها رطب، لونه؟ لا لون له. ربما كان أبيض يوماً. كانت تنظر إلى أقدام المارة فقط. عيناها على مستوى الأقدام دائماً، تمد يديها بلا كلمة، بلا حركة. وإن اقتربتَ منها، جفلت.
في النهار، فتاة أخرى على مشارف المراهقة. عينان سوداوان، شديدتا التركيز. تربط شعرها كذيل حصان. حافية أيضاً، لكنها ليست مغطاة بالطين مثل الصغيرة. شعرها خفيف، ملبّد. ترتدي فستاناً واسع الأكمام، وتحته بنطال طويل. هي التي تقود. تتكلم، تشحذ، تغضب، تتوسل، تطرق أبواب العالم بصوتها. كانت أحياناً هادئة، أحياناً حازمة، وأحياناً تصرخ. تجأر. الطفلة، ذات الثلاث سنوات أو أقل أو أكثر بقليل، تقول "يا عمو" و"يا خالتو" في النهار، بينما في الليل، تنخفض عيناها إلى حيث تسير الأقدام. بعض المارة، حين تلامسهم لحظة من الذنب أو الحزن أو الغضب أو رحمة مؤقتة، يعطون النقود. البعض الآخر يتحاشاهم.
في ساحة باب توما
في أحد الأيام، أمسكت سعاد، هذا الاسم الذي أعطتني إياه صاحبة العينين السوداوتين بعد تفاوض طويل مقابل مال، بتنورة امرأة مرت بجانبها. سعاد قالت لي إن اسمها كذلك، ثم أعطتني اسماً آخر في يوم آخر. كل معلومة بثمن، وكانت تعرف ذلك تماماً. ذكية، مدرّبة، وتعي قواعد اللعبة. عندما شدّت سعاد تنورة المرأة، صفعتها الأخيرة، صرخت وهربت، تردد خلفها: "حرامية! حرامية!". سعاد لم تصمت. صرخت هي الأخرى: "كذابة!" ثم أطلقت شتيمة من العيار الثقيل، وبصقت على الأرض، ونهرت البنتين معها لتلحقان بها. لكنها كانت قد تركت يد الصغيرة. والصغيرة، المذعورة، بدأت تركض خلفها وحدها.
لو أردتَ الجلوس في ساحة باب توما، فهناك مقاعد ما زالت باقية من حديقة صغيرة، لم تعد حديقة منذ وقت طويل. جلستُ مع سعاد، وافقت أن نجلس ونتحدث، لكنها بدأت بقول حاسم: لا أريد أن أقول شيئاً، وإذا كنتِ قادرة على مساعدتي، فافعلي، ثم انصرفي. سألتها: أين أهلك؟ قالت باقتضاب: ماتوا. سألتها عن الفتاتين، هل هما أختاها؟ قالت: لا. قلت: إذاً من بنات مَن؟ نظرت إليّ تلك النظرة الساخرة، كأنها تقول: هل أنتِ غبية؟
في تلك اللحظة بدت وكأنها في الثلاثين، رغم أن ملامحها ما زالت مراهقة. قوية، واثقة، صلبة. فكرتُ أنها لا بد تتعرض للتحرش، فهي جميلة، لكن القذارة التي تغطي وجهها أوقفت هذا الخيال. تبدو تلك القذارة جزءاً من الزي، ضرورة يومية. قلت لها بوضوح: أستطيع مساعدتك. سألتها: أين تنامين؟ أشارت إلى الشارع. قالت: في الشارع. ثم أضافت: إذا أردتِ مساعدتي، أعطيني نقوداً. قلت: ألا تريدين مكاناً للنوم؟ نظرت إليّ تلك النظرة الفظيعة، ثم هربت. كل المعلومات التي جمعتها خلال الأيام السابقة أكدت أن من يُشغّل هؤلاء الأطفال هم عصابات موزعة في أنحاء دمشق.
سعاد بالتأكيد ولدت في بدايات الثورة، لم تعرف عن سورية التي عرفناها شيئاً، قضت معظم طفولتها في الشارع. فتاة قوية. صلبة. جاهزة لتفترسك. تدافع عن البنتين بشراسة، لكنها لا تعترف بأنهما شقيقتاها. ربما لم تكونا فعلاً، رغم حدسي أنهما كذلك.
في الليل، تصمت سعاد. البنتان تصمتان. والولد الذي يرافقهنّ يصمت أيضاً. بعد العاشرة مساءً، كنت أروح وأجيء أمامهنّ، وأقول لها: أنا أسكن هنا، إذا احتجتِ شيئاً أنا موجودة. تتجاهلني تماماً. أقف في زاوية بعيدة، حيث لا تصلني إنارة الشارع الخافتة، وأراقب الفتيات الثلاث والصبي. سمعتها تناديه "محمد". أما الصغيرة، بالكاد تمشي. تجلس على الأرض، تمد رجليها في طريق المارة. إذا لم ينتبه أحدهم وداس قدمها، تصرخ. يرتبك، يعود ويعطيها نقوداً. أسلوب واضح، مدروس. تأخذ النقود، تخبّئها في يدها الصغيرة، تقبض عليها بقوة. بعد قليل، تمد يدها لسعاد، تعطيها النقود. سعاد تضعها في جيبها. ثم تمرّ النقود إلى يد محمد. بعدها، لا أعرف إلى أين يذهب. يختفي لساعات، ثم يعود.
"مو إخواتي"
تمشي سعاد كما لو كانت رجلاً. عندما تكونين فتاة تنام في الشوارع، لا بد أن تتعلمي السير كأنك لا تخافين أحداً. تمشي مثل رئيسة عصابة صغيرة. تنظر بثقة إلى من حولها، لا تتوسل، لا تذل نفسها. لا بد أنها تعرضت لتحرش، وربما أكثر. جميلة، مشرّدة، فتية. لا بد أن كثيرين قالوا لها "تعالي معنا". أخذت أفكر! ربما كثيراً.
في اليوم التالي بعد أن هربت مني في ساحة باب توما، قلت لها إنني أستطيع أن أصلها بجمعيات تهتم بها وبـ"أخواتها". قالت بازدراء: "مو إخواتي". ثم أضافت: "هاتِ حق ساندويشة". هزت رأسها بسخرية، ومشت أمامي مشية مسرحية ساخرة، عينها تلمع باحتقار الدنيا، وكأن العالم سينفجر منها. شعرها الخفيف الملبد بدا كأنه على وشك أن يشتعل. كل السخرية والحقد والعار الذي يمكن أن يُحمل في عين واحدة، رأيته في عينيها. وكان لها كل الحق. كل الحق أن تنظر لي، للعالم، بهذه الطريقة.
وضعت يدها على خصرها، فتحت ساقيها قليلًاً كما يفعل زعماء العصابات، رفعت رأسها إلى السماء، وأشارت لمحمد، الذي كان يقف على مبعدة منها، دائماً في نفس النقطة، كأنه مرسوم هناك. اتجه صوبها، وأنا أدرت ظهري، وغبت في نهار المدينة.
مع اقتراب منتصف الليل، يبدأ التعب بالظهور على وجوه الفتيات. يفترشن الأرض، حافيات، تمدّ الواحدة منهن قدميها المغطاة بالطين حتى منتصف الزقاق. على من يمر أن يتفاداهن، أن ينحني بحركته، أن يعترف بوجودهن ولو لحظة. كنّ مسترخيات، متعبات، لا ينطقن بحرف. الولد يروح ويجيء. يختفي، ثم يعود. لحقت به مرة. كان يسير في زقاق آخر نحو ولد آخر، يقف على مسافة. ولد صغير، نحيل، لكنه حيوي. كأنهما يؤديان مهمة. على مقربة منهما، مجموعة أخرى لم أرها من قبل. فتاتان، ربما بين التاسعة والعاشرة، ومعهما طفلة لا يتجاوز عمرها السنتين، بالكاد تقف. تبدو متعبة، متسخة، تترنح. المجموعات تتوزع، كل منها في رقعة. صبية تمرّ بين هذه المجموعات تربطها ببعضها، كأنهم وسطاء. وأولاد آخرون، يتحركون وحدهم بخفة. يتوسلون، يصرخون، يشتمون.
ولد، ربما في السابعة من عمره، عندما لم ألتفت إليه، وواصلت طريقي، شتمني. ثم ركض مبتعداً. إنهم يفعلون ذلك، ينبتون في كل مكان. ربما هنا، في ساحة باب توما والمدينة القديمة، يعرفون أن نسبة الزوّار والغرباء كبيرة، لذلك يتواجدون بهذه الكثافة. كانت تلك فرصة لهم، ليعتاشوا قليلاً، أو لينشطوا، وتُدار حركتهم من قبل من وزّعهم على الحارات. أتذكّر المرأة التي قالت لسعاد: "حرامية!" ثم طلبت من الجمع المتجمهر أن "يلحقوا بهذه المتشرّدة الحيوانة"، كما وصفتها. قالت إن هؤلاء الأولاد يشكّلون خطراً أكبر من كل الأخطار المحيطة بسكان دمشق، وعندما اقتربت منها وقلت: "إنها مجرد طفلة"، ردّت: "هؤلاء يقتلون من أجل ألف ليرة! أنا أعيش هنا، وأعرف ما يفعلون. إنهم شبكة منظّمة. هؤلاء ليسوا أطفالاً. هؤلاء مجرمون". ثم نظرت إليّ تلك النظرة التي تحمل تعالياً وقرفاً، وهزّت تنورتها كما لو كانت تنفض عن نفسها الغبار. أو عن روحها الذنب، وتمنح نفسها، وحدها، امتياز النجاة.
لا أحد يستطيع الجزم من أين أتى كل هؤلاء المشردين. لكنها الحرب الطويلة. وفي الليل، يتحولون إلى كائنات صامتة. ربما بسبب التعب. وربما لأن عملهم في النهار يؤتي ثماره ليلاً، عبر هذا الصمت. وعرض الأجساد. أجساد شمعية موحلة. أراقبها عن كثب، تحت سماء شاهدة على عسف البشر وفجورهم. أجساد تستلقي في كل الأمكنة وتصير جزءاً من المشهد الاعتيادي، من لوحة دمشق الجديدة. دمشق ما بعد الحرب. من يرى الخراب المحيط بدمشق وريفها وبلداتها، ربما يخمّن من أين جاء هؤلاء الأطفال. التقيت فتاة تعمل في إحدى منظمات المجتمع المدني. أصرت على إخفاء هويتها واسم المنظمة. قالت إن بعض الأطفال يأتون من الشمال، وليس بالضرورة أن يكونوا جميعاً من أيتام الحرب. قالت إن هناك أطفالاً يُرسَلون من أهاليهم إلى الشارع، للشحاذة، مقابل طعام أو ما تيسّر. سألتها: وهل هناك كثير من العائلات التي ترسل أبناءها؟ قالت: نعم، هناك كثير. وهناك فتيات صغيرات يتعرضن للتحرش. عندي ثلاث حالات اغتصاب لطفلات. أطفال وطفلات يظهرون فجأة، ثم يختفون فجأة. ولا أحد يعرف ماذا يحصل لهم.
لم أكن أنوي، وأنا أبدأ هذا البحث عن حياة هؤلاء الليليين الذين ينامون في الشوارع ويتمشّون بيننا، أن أعود إلى الإحصائيات، أو أن أطرق أبواب المنظمات المعنية بحقوق الطفل. كان همّي الوحيد هو ملاحقة الحيوات الشخصية للفتيات الثلاث. كنّ صامتات. سعاد، الكبيرة، كانت وحدها المسموح لها بالكلام.
في اليوم السادس، وعند الساعة الحادية عشرة ليلاً، كانت الفتيات ممددات في الشارع. أجساد صغيرة متعبة، أقدام موحلة، أيادٍ ممدودة تنتظر قطعة نقود من مارٍّ شغله ضميره أو لحظة شفقة. تتحرّك سعاد، الفتاة الأكبر، جيئةً وذهاباً إلى آخر الزقاق، ثم تعود كمن يراجع موقعه في ساحة معركة. في تلك اللحظة، كانت المدينة تتنفس ببطء، وكان شباب الهيئة يمرّون بين الناس، يراقبونهم دون أن يرمشوا، والناس تنظر إليهم بفضول أو ريبة أو لا مبالاة. مجموعات تتقاطع وتتجاهل، والبعض يمشي مسرعاً كما لو أنه يهرب من احتمال اللقاء بعينٍ تتّهمه بالصمت. اقتربتُ من سعاد مجدداً. هذه المرة حاولت أن أكون أكثر وضوحاً. قلت لها إنني كاتبة وصحافية، وإنني أريد مساعدتها. نظرت إليّ باشمئزاز وسألت: "كم بتعطيني مقابل اللي بحكيه؟".
"إنتِ شو خصّك؟"
لم يكن سؤالاً بريئاً، بل تأكيداً على علاقة القوة التي فرضتْها منذ اللحظة الأولى. كنت أكرر عليها في كل محاولة: "أريد مساعدتك"، وأقوم باتصالات أمامها لتصدق. لكنها في كل مرة كانت تطردني، أو تسخر مني، أو تطلب نقوداً بلا مقابل. حين اقترحت أن نعتني بالطفلة الصغيرة، تلك التي لا يتجاوز عمرها الثلاث سنوات، ضحكت سعاد وقالت بسخرية: "أي صغيرة؟ ما في حدا صغير هون". صوتها كان حاداً، وبدت كأنها تلفظ كل شيء دفعة واحدة، لكنني لمحت شيئاً يتحرك في عينيها للمرة الأولى منذ أن عرفتها؛ بريق ماء، خيط دمعة، شيء رقراق كاد يسقط، ثم تماسك. قالت لي بلهجة مرهقة ومهزومة: "خلّينا نسترزق واتركينا بحالنا"، ثم عادت وجلست قرب الفتيات الثلاث، واحتضنتهن كما لو أن العالم كله يكمن في هذا الاحتضان.
سيقانهنّ الموحلة كانت تلمع تحت ضوء الشارع البارد، كعيدان خشبية متآكلة. وعندما حاولت الاقتراب مرة أخرى، صرخت: "وإنتِ شو خصّك؟"، ثم مدت يدها، وقبل أن تنصرف، أطلقت عليّ شتيمة ثقيلة، لم أستطع الرد عليها. ابتعدت. شعرت أنني فقدت القدرة على اختراق هذا الجدار. كنت واثقة أن شخصاً ما سيأتي قريباً ليأخذهن إلى مكان يختفين فيه قبل أن يُطلقن من جديد صباحاً.
تجاوز الوقت منتصف الليل، كانت سعاد تحتضن الصغيرة، وقد أغمضت عينيها من التعب. عدد المارّة بدأ يقل. مرّ عاشقان، لا يتلامسان، لكن عيونهما كانت تشي بتلك النظرة الفاضحة. توقفت الفتاة العاشقة قليلاً، نظرت إلى الفتيات الثلاث، وضعت يدها على فمها وأغمضت عينيها. كانت نحيلة، ترتدي بنطال جينز ضيّقاً، ويبدو أنها كانت تبكي، في حين أخرج الشاب قربها مبلغاً ومده نحو الفتيات. المنظر كان مفجعاً. خاصة تلك الطفلة التي بالكاد تبلغ الثالثة، أو أقل. كانت تبدو أقرب إلى عامين، نحيلة كأنها تعاني فقر دم، جسد صغير بالكاد يصمد أمام البرد، شبه عارية، حافية، مستلقية على الأرض كحجر مهمل في زقاق منسي.
في اليوم التالي، قال لي صاحب المحل المجاور: "هي ضرورات الشغل يا مدام". قالها كمن يقدّم تفسيراً بسيطاً لمشهد معقّد. وعندما صارت الساعة الواحدة ليلاً، لم أعد قادرة على الاحتمال. كنت أرتجف من البرد، أدور حولهن ولا أعرف ما الذي ينتظرني أو ينتظرهن، ثم تركتهن وعدت محمّلة بخواء مرعب.
في الرابعة والنصف صباحاً، استيقظت مذعورة. لم تمضِ سوى ثلاث ساعات على نومي، كنت أعرف أنني لن أستطيع إغلاق عيني من جديد ما لم أراهنّ، ما لم أتأكد أنهن ما زلن هناك، في مكانهن المعتاد عند زاوية الزقاق. خرجت من البيت قبل الفجر بقليل، ركضت في الأزقة المبللة بمطر دمشق الخفيف، وأنا أتساءل عمّا سأجده.
عندما وصلت، كان المشهد كما تركته. الفتيات الثلاث كن نائمات، وكأنهن قد تحوّلن إلى كائنات من طين وضوء؛ ملفوفات ببطانية رمادية رقيقة بالكاد تكفي لتغطية نصف أجسادهن. سعاد، الفتاة الأكبر، احتضنت الصغيرة ذات الأعوام الثلاثة، بينما كانت الثالثة تمسك بيدها وتضع رأسها على كتفها. كان محمد، الصبي الذي يظهر ويختفي مثل ظل، نائماً في آخر الزاوية، تغطيه بطانية مختلفة. المطر الناعم انهمر فوق رؤوسهم. كانت الأرض مبللة، والهواء بارداً، والسماء ثقيلة. ومع ذلك، لم يتحرك أحد. فقط خدودهم التي تساقط عليها الرذاذ، وأنوفهم التي بالكاد تظهر من تحت البطانيات.
كانت شفتا سعاد مزرقّتين من البرد، ووجهها جامداً كصخرة. الصغيرة كانت تغطّ في نومٍ عميق، ومخاطها يسيل بهدوء، وكأنها اعتادت أن تنام بهذه الطريقة. البنت الوسطى كانت جميلة على نحوٍ مخيف. جمال هشّ، يتوسل النجاة. اقتربت ببطء، حذرة من أن أوقظهن أو أثير فزعاً. ومع ذلك، فتحت سعاد عينيها، ولم تتحرك. فقط نظرت إليّ، بتلك النظرة الساخرة، العميقة، الحادة كحد السكين، ثم رمشت بعينيها تحت المطر. لم تقل شيئاً. لم تحرك عضلة من وجهها. لكن النظرة كانت كافية. كانت كل ما يمكن قوله. لغة كاملة من دون حروف. أردت أن أسمع منها شيئاً. أي شيء. جملة تفُكّ هذا الصمت. حكاية واحدة. لكنها لم تفعل. لم تقل من أين جاءت، ولا من هي تلك الطفلة الصغيرة، ولا من يكون محمد. تركتني معلّقة، مثلي مثل آلاف السوريين الذين يمرّون بهؤلاء الأطفال كل يوم، ويعودون إلى بيوتهم ممتلئين بالخواء والأسئلة.
في لحظة، راودتني فكرة أن أجلس قربهن. أن أفعل ما تفعله الجدة الطيبة في القصص. أن أسرد حكاية، أن أغطيهن جيداً، أن أشتري لهن إفطاراً ساخناً. كان يمكن أن يكنّ حفيداتي. لكن بدلاً من ذلك، تركتهن. ومشيت في شوارع دمشق القديمة، تلك الأزقة التي كانت يوماً مأوى للعشاق والذكريات، وصارت اليوم مأوى للغضب، والتشرد، والمصائر المجهولة.
المطر الذي كنت أظنه احتفالياً بعد سنوات المنفى، صار كالسياط. لم يكن يلامس وجهي، بل يجلده. كنت أبتعد، وأشعر بالخذلان يثقل ظهري. خذلانهن، خصوصاً خذلان سعاد التي كانت هناك، رغم كل شيء، تحرس الفتاتين كلبؤة جريحة. كان من الممكن أن يكنّ مجرد أدوات في شبكة منظّمة لاستغلال الأطفال. وكان من الممكن أن يكنّ حقاً أخوات. أو أن يكون محمد شقيقهن. وربما لا أحد منهم يعرف الآخر، وربطتهم الحياة فقط، هكذا، على الرصيف، في هذا الزمن المهزوم. لكن الشيء الأكيد الوحيد أن سعاد، تلك الفتاة الصغيرة ذات العينين الميتتين، كانت تقف سداً صلباً بين الطفلتين. كانت تحميهما بكل غضبها وصمتها. وفي نظرتها الأخيرة، كانت تقول: "اقتربوا وسأقتلكم".
في النهاية، هذا ليس تقريراً. هذه ليست سوى كتابة مفككة، ضد التوثيق، ضد الأرشفة. ضد أن تُحصر الطفولة في أرقام وإحصاءات. هذا مجرد كلام يمشي حافياً مع سعاد، ويجلس قربها، في صمتٍ، تحت مطرٍ لا يتوقف. ليتني قلت لها: "أنا آسفة. فقط آسفة".
(روائية سورية)

.png)
 منذ ١٥ ساعات
٨
منذ ١٥ ساعات
٨






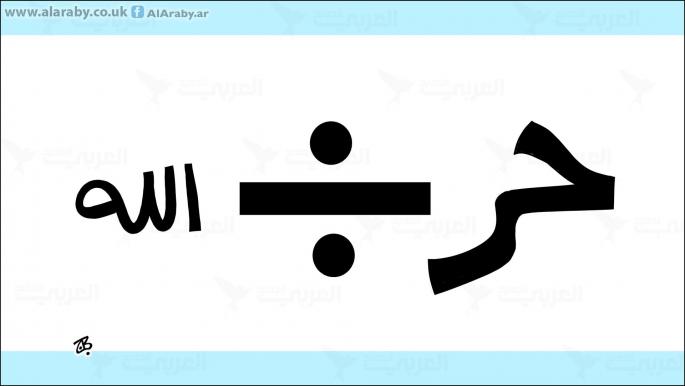

 English (US) ·
English (US) ·