وأنت تصعد من جوار السيف الدمشقي الشهير في ساحة الأمويين بدمشق، باتجاه حيّ المهاجرين، سيلاقيك في أعلى الشارع تمثال العقيد الشهيد عدنان المالكي شامخاً بزيّه العسكري، كحاله منذ سبعين عاماً مضت. وربما أمكنك رؤية الحزم والتصميم في عينيه، لولا إصابته الجديدة بعدد من الطلقات النارية التي طاولت عينيه ووجهه، فشوّهت معالمهما، كما أحدثت ثقوباً متعددة في قبعته وصدره.
وكان السوريون في 19 آذار/ مارس من الشهر الجاري قد تداولوا خبر استهداف التمثال بالرصاص وتخريب متحفه القريب وسرقة محتوياته، ولقي خبر استهداف التمثال استنكاراً واسعاً من أوساط سورية عامة، ومن الدمشقيين على وجه الخصوص، الذين شعروا أنَّ التصويب عليه كان تصويباً على وطنيتهم أولاً، وعلى ذاكرتهم الجمعية ثانياً؛ فهم لا ينظرون إلى التمثال الرمز لابن مدينتهم القادم من حيّ الشاغور بوصفه قامة وطنية قاتلت المستعمِر الفرنسي وحاربت في فلسطين فحسب، بل يشعرون أنه امتداد واستمرارية لـ رمزية ابن آخر لتلك المدينة، وهو يوسف العظمة الذي ذهب إلى معركة ميسلون عام 1920 بكامل يقينه أنه لن يعود منها حيّاً، لكنّه أبى أن يكتب التاريخ أن الفرنسيين دخلوا إلى دمشق بلا مقاومة من أهلها.
اختلاف على التفاصيل والدلالات
اتفاق السوريين على حقيقة حدوث الاستهداف، وعلى استنكاره مجتمعين، لم يمنعهم من الاختلاف، كحالهم هذه الأيام، على التفاصيل والدلالات. فأكد فريق منهم أن حدوث إطلاق النار على التمثال حصل في الأيام الأولى من تحرير دمشق، أو حتى قبل تحريرها بأيام، وزعم آخرون حصول جريمة الاستهداف مؤخراً. وامتدّ الخلاف إلى هوية صانع التمثال، بين الفنان الحلبي محمد فتحي قباوة، والفنان الدمشقي أكرم الشوا، الذي قيل إن دوره اقتصر على صبّ التمثال وتنصيبه بسبب مرض ألمّ بمصمّمه قباوة في حينه.
استُهدف التمثال بالرصاص وخُرّب المتحف وسُرقت محتوياته
ومهما يكن من أمر الخلاف والاختلاف، إلّا أن التمثال منذ انتصب في ساحة حملت اسمه، تحوّل إلى واحدة من العلامات الفارقة في هذا الحيّز من المدينة، وأسهم في تشكيل ذاكرة المكان، وفاضت سطوته على المحيط فاكتسب الحيّ المجاور اسمه، "حي المالكي"؛ وهو أحد أبرز أحياء دمشق.
وقد يكون من سخرية القدر أن حافظ الأسد وابنه، رغم عبثهما بالذاكرة المكانية ونثر الأسماء الخاصة بهما على الجسور والمباني والمنشآت والأحياء الجديدة في عموم سورية، فإنهما عاشا في هذا الحي تحت ظلال اسم المالكي وفي كنفه.
لم ينزف التمثال دماً، كما حدث مع صاحبه حين اغتيل عام 1955 في الملعب البلدي، ويمكن بقليل من الترميم والصيانة أن يستعيد الجسد البرونزي رونقه وبهاءه، لكنّ السوريين في هذه المرحلة الحساسة من تاريخهم يدركون أن النزف المعنوي للتمثال هو صورة أخرى عن نزيف مماثل في أرواحهم، وأن الرصاص الذي استهدف التمثال كان يستهدف الذاكرة البصرية للمكان بما كُثفت وتقاطعت مع ذكريات كامنة في وجدانهم وانتماءاتهم، ويدركون أن الرصاصات التي أصابته هي مقدمة لاغتياله المعنوي، وإزالته من المكان.
وبالقدر الذي عمِد فيه النظام السابق خلال عقود سيطرته إلى إضعاف المناعة المجتمعية وتدمير الذائقة الجمالية وتشويهها، فإن الآليات الدفاعية للمجتمع السوري لم تكن غائبة، وإن كانت في حدودها الصامتة أو الكامنة، في مقاومة حضور النظام المستمر في الذاكرة البصرية للمكان، بما يؤسّس لذكريات يتموضع فيها، فلا يمكن محوها بسهولة. إذ سعى المجتمع بالسرعة اللازمة والفرح المصاحب إلى إزالة تلك العلامات والرموز وتحطيم التماثيل المرتبطة بالنظام، في محاولة منها لمحو الحقبة السابقة، وتنقية الصورة البصرية من التشويه الذي طاولها.
وإذا كان الإصرار على إزاحة علامات السلطة الآفلة هو السمة الأبرز، فإن الوعي المجتمعي في سورية كان حاضراً للتمييز بين ما يخصّه من رموز وبين ما فُرض عليه بالعنف والإكراه، وإذ يتشبث المجتمع بما ينتمي إليه، فإنه يتلمّس هويته الذاتية في مسار استعادته العافيةَ المسلوبة.
استعادة العافية
إذا كانت الناحية الشكلية كافية للتمييز بين ما يعبّر عن ذاكرة المجتمع وبين ما يُفرض عليه، فإن الناس العاديين لطالما تفاعلوا مع تماثيل أحبّوها واقتربوا منها وتلمّسوها وتساءلوا عن جماليات فيها، والتقطوا صوراً إلى جوارها، وكوّنوا ذكريات مشتركة معها، فيما كانت التماثيل المفروضة تمثّل عائقاً للمكان وعبئاً عليه، فتثير النفور، وتحدّ الحركة، ولا أحد يقترب منها؛ سواء بداعي الرهبة أو البغض، كما أنه لم يكن لها وظيفة سوى إظهار علامات السيطرة ونفث الرعب في عيون ناظريها.
دفاع عن الهوية البصرية وترسيخ للجذور النفسية والاجتماعية
وفي إطار استعادة العافية، أوقف السوريون أكثر من محاولة في حلب لإزالة تماثيل احتضنتها المدينة طويلاً، إذ يرى الحلبيّون أنها تخصّهم وتعبر عن هويتهم المجتمعية، وتشكل جزءاً من ذاكرتهم المشتركة مع المكان، فارتفع الصوت عالياً حين أُزيل تمثال أبو فراس الحمداني من موضعه، وجاء التبرير الرسمي سريعاً بأن إزالته لترميمه وليس لاستبداله بآخر، وجرت بالفعل إعادة التمثال.
وعلى نفس المنوال، يحتدم الجدل ويشتدّ الاعتراض المجتمعي على تصميم جديد قدمته إدارة المحافظة لساحة سعد الله الجابري في حلب، وإذ يمتد الاعتراض إلى التصميم ذاته، فإن أكثر ما يتركز على فكرة إزالة نصب الشهداء، ذلك النصب الذي تآخى مع الساحة منذ عام 1985، وبات واحداً من معالمها بحجره الأصفر، لمبدعه الفنان الحلبي عبد الرحمن المؤقت.
اقتلاع أم تجديد؟
يحيلنا الدفاع عن الذاكرة البصرية للمكان إلى الدفاع عن ذكرياتنا التي تأصّلت فيه، وربّما بمعنى أكثر واقعية، فإن الدفاع عن الذاكرة البصرية هو ترسيخ للجذور النفسية والاجتماعية التي أسهمت في تأسيس دعامات وجودنا المكانية. وقد يكون من نافل القول أنّ العلامات المكانية لا تكتسب صفة القداسة، ومن المستحسن لها ألّا تكون أبدية، وربما من المهم استبدالها، لكنّ استبدالها الطوعي والتوافقي محمولاً على فكرتَي التجديد والتطوّر أمرٌ يختلف كل الاختلاف عن اقتلاعها القسري.
فالاقتلاع العنيف والمباغت لتلك العلامات الفارقة في المكان غير مبرّر، وهو يكافئ اقتلاع الإنسان من جذوره أو بتره عنها، ما يجعله عرضة للإزاحة باستمرار، وتضطرب علاقته بالمكان الذي يصبح بلا ملامح ويمكن استبداله بآخر لا يتقاطع مع الوجدان ولا يولدّ محفزات الرغبة في الدفاع عنه. وربما في حال كهذه، يجدر السؤال: من نحن بلا أمكنة تشدنا بوازع الذكريات والحنين للعودة إليها، ومن نحن بلا أمكنة تتشابه معنا؟ فلا نشعر أننا عابرون أو غرباء فيها.
* كاتب وباحث من سورية

.png)
 منذ ١ يوم
٣٢
منذ ١ يوم
٣٢




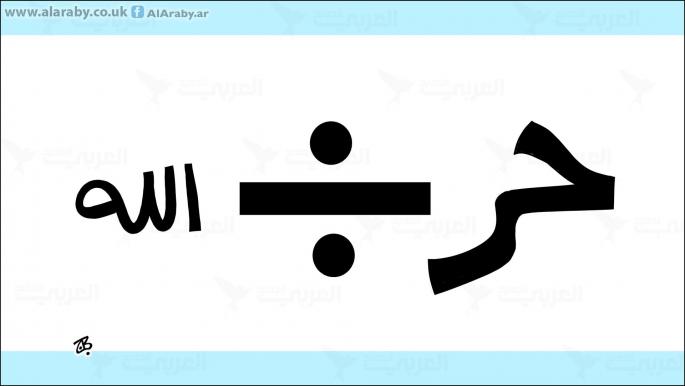



 English (US) ·
English (US) ·