باستثناء الدراما المصرية، ثمة طلاق غير مفهوم أو مبرّر مع النص الروائي، فحتى مطلع هذه الألفية، كانت غالبية الأعمال الدرامية المصرية مأخوذة عن نصوص أدبية أصيلة (رواية أو قصة قصيرة أو مسرحية)، بل إن روائيين كباراً مثل نجيب محفوظ، وهو إلى أيامنا يتمتع بمكانة استثنائية، كانوا منخرطين في صناعة الدراما (السينما تحديداً)، يؤخذ منهم أو يُقتَبس عنهم، وهو ما نجده في التيار السائد في السينما الأميركية التي عرفت كتّاباً في مستوى جون شتاينبك، وإرنست هيمنغواي، وسكوت فيتزجيرالد وسواهم، إما كتاباً لأفلام أو اقتباساً عنهم ومنهم.
هذا أغنى الدراما، فلم تعد مجرد فرجة، وهي كذلك من الأساس، بل مختبراً للأفكار في معاينتها المصائر والتحوّلات بل والتحديق في عتمة الإنسان ومغاليقه التي تحتاج طَرْقاً مرة تلو أخرى على بوابات غموضه وأسراره ولا وعيه.
ومن تابع الدراما الرمضانية هذا العام، يخلُص إلى بؤس "الورق"، أي السيناريوهات المكتوبة، ولا ينسى كاتب هذا المقال ما قاله له صلاح أبو سيف قبل أزيد من ثلاثين عاماً، في معرض مراجعاته لتجربته السينمائية وانتقاده للراهن السينمائي آنذاك: "ادّيني ورق وبعدين حاسبني وشوف حعمل إيه"، وهو ما جعله يلجأ في بداياته إلى نجيب محفوظ، لا للاقتباس عن رواياته بل ليتعاون معه في كتابة السيناريوهات، وهو ما أصبحنا نفتقر إليه في السنوات الأخيرة.
هل ثمة شح في النصوص؟ على الإطلاق، ومن يراجع عدد الروايات المقدمة للجائزة العالمية للرواية العربية، وتُعرف باسم بوكر العربية، يجد أن ما لا يقل عن 120 رواية يتقدّم أصحابها للجائزة سنوياً في العقد الأخير على الأقل، ويقفز العدد في بعض الأعوام إلى ما يزيد عن 180 رواية، والأمر نفسه لكن بمعدلات أكبر وأعلى نجده في جوائز كتارا (قطر)، فمعدل عدد الروايات المنشورة أو غير المنشورة المقدمة للجائزة يقارب ألف نص روائي سنوياً، بما فيها بالطبع الروايات القطرية التي خُصصت لها جوائز منفصلة. ومن المستغرب والحال هذه الحديث عن شح روائي، إذ ربما يصح الشح في الخيال أو المستوى الرفيع، لكنه لا يصح في عدد النصوص التي يمكن تكييف بعضها أو حتى كثيرها لتصبح مناسبة للدراما، لكن المشكلة غالباً تتعلّق بشركات الإنتاج التي تذهب إلى الحلول الأسهل بالاستعانة بكتاب دراما تُقترَح عليهم أفكار ويُطلب منهم كتابتها، وهو ما يعكس نفوذ بعض النجوم أو خفة بعض المنتجين.
ويحدث هذا ضمن شروط ما يسمى السوق، والأخير متخيّل بالمناسبة ومفترَض، أي أنه ليس حقيقياً بل متغيّر ومن الصعب ضبطه أو التبنؤ بمساراته، وهو ما ثبتت صحته في السنوات الأخيرة التي راهن فيها المنتجون على محمد رمضان ممثلاً أو محمد سامي مخرجاً، وكلاهما قُدّما باعتبارهما مرآة هذا السوق وحصانيه الأسودين، وكانت النتيجة ما رأيناه في السنوات الماضية من تنميط وتكرار، إلى أن تلقّى هذا التيار الضربة القاصمة من أعمال أقل تكلفة إنتاجياً، وأقل اكتراثاً بمعايير السوق التي لا نعرف ما هي، ما انتهى بسامي إلى الاعتزال، ليس نقصاً في الاحتراف، وهو محترف بالمناسبة، بل لسوء الاختيارات وبؤس الرهانات.
فخلال السنوات الأربع الأخيرة، شاهدنا قصصاً مضادة للسائد تستحوذ على أعلى المشاهدات (فاتن أمل حربي 2022، تحت الوصاية 2023، لام شمسية 2025) وإلى حد ما "نعمة الأفوكاتو" - 2024، وهو بالمناسبة من إخراج محمد سامي الذي أهدر تميّز الحلقات الأولى من عمله ذاك بانعطافته البائسة للشعبوية والخفة في بناء الأحداث، فإذا هي فيلم هندي (بمعنى تجاري ومبتذل ليس أكثر) في نهاية المطاف.
وفي الأعمال التي أُشير إليها تستطيع الحديث عن "الورق" لا الارتجال، وعن البناء الدرامي لا الانعطافات الدرامية غير المبررة، كما تستطيع الحديث عن فن يعاند معايير السوق إذا وُجدت، ويكسرها ليصبح هو التيار السائد ولو خلال البث على الأقل.
وهذا بالإمكان الدفع به برفق لكن بإلحاح ليصبح السائد غالباً وليس مؤقتاً، لو التفتت شركات الإنتاج إلى النصوص قبل الرهان على نجومية هذا الممثل أو تلك الحسناء، والقول إن الجمهور يريد سي السيّد أو سيّد الناس الذي يأتي ما يأتيه الأوائل.

.png)
 منذ ٢ أيام
٢٤
منذ ٢ أيام
٢٤





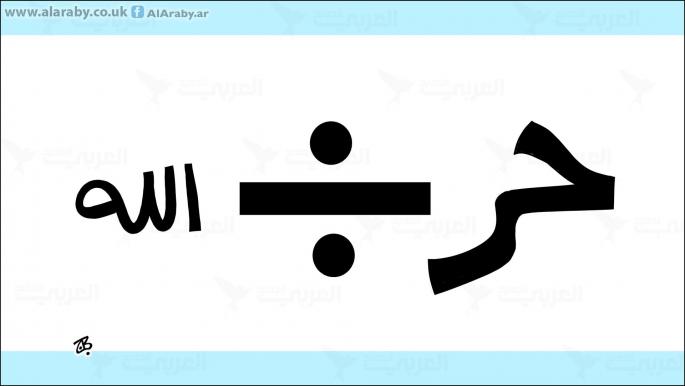


 English (US) ·
English (US) ·