هو ابن حكاية، والحكاية قدره حتى في موته، وموته يُروى حكاية غامضة. هل طريقة الموت هي الحكاية، وهل الحكاية هي أصلاً التي في بطن يحيى حتى قبل أن يموت. ابن حكاية وقد مات ولا تتركه الحكاية أبداً، هل الحكاية تُنسج على قدر صاحبها، أم أن صاحبها يتدخّل من بعيد في صياغة متاهة الحكاية؟
يحيى حكاية، وهل في تلك الحكاية كان يُعشّم، حتى يحيى نفسه، بأن تستمرّ في الإدهاش بعد موته لما يقارب خمسين سنة إلا قليلاً؟ نحن عموماً في إبريل/ نيسان، شهر الأكاذيب، ولكن يحيى كان حقيقة، وما زالت الحقيقة ترتدي أثوابها الزاهية كلّ إبريل من كلّ سنة، كي نحكي يحيى الطاهر عبد الله بشكل آخر، بالطبع لم يُعشّم يحيى في ذلك، ولم يُخطِّط له أبداً، ولم يحلم به أبداً، ولكن هذا قدره، إنه في كلّ إبريل من كلّ سنة نراه في حكاية أخرى أكثر جمالاً وألقاً، وكأنّ الكتابة تراهن على تجديد جمال ثوب صاحبها فقط، في مخيلة المتلقّي والمحبّين والعشّاق والنقّاد، وأظن أن يحيى كان يكره النقّاد، ويحبّ العُشاق من بعيد.
يحيى عاشق البسطاء والأحرار في غرف ضيّقة بالسيّدة زينب، أو امبابة أو بشتيل، وينتظر ثورة حتى هوجاءَ تأتي من البحر، أو من خيام الغجر، كان يحيى غجريّاً أدمن الكتابة من دون أن يعرف السبب، مدمناً عنيفاً جاء من الجنوب يحمل نباله وسهامه على كلّ شيء، كان يسكن إلى صحبة من قدماء لاعبي كرة القدم في مشرب قديم بالسيّدة زينب، كعبده نصحي وآخرين، يتغندر يحيى بلباقة لسانه وفتوته ونزقه أحياناً في المكان ويكتب، وينتقل من السيّدة زينب إلى امبابة، يختفي ويظهر شهاباً، كما وصفه الناقد الراحل شاكر عبد الحميد، ثمّ يغيب الشهاب في حادث سيارة في الهرم، من دون أن يغيب نور الشهاب حتى بعد نصف قرن، إلا القليل. على ماذا كان يراهن يحيى؟ لا شيء سوى أن يكون نفسه بجنونه وغضبه كلّه. مات يحيى، ولكنّه عاش بفصاحة الكتابة وجنونها أكثر ممّن مات من سنة أو سنتَين، فما السرّ في ذلك؟
ليس في أقوال يحيى التي لم يتركها خلف ظهره إشارة على معرفة أو تنظير للكتابة أبداً، كان غجرياً وقد خرج من كهف، يكتب ويغضب ويقرأ، ثمّ يترك دماء معاركه خلف ظهره، من دون أن يسأل عن السبب، أو لماذا كان يخطّط لحرب طويلة. ولكن، جاءه الموت عنيفاً وقاسياً في إبريل، ومن دون أي مقدّمات أو مرض أو أي عجز.
كان يحيى عجيباً حتى في موته، رغم أنه كان يحرص على الحياة بفتوة، ما يفصلنا عن موته نصف قرن إلا قليلاً، وما زال يحيي بهياً، ما زال يحيى يطلق الرصاصات على الكتّاب البلداء الذين همّهم الحصول على الكمّ الورقي الضخم من عدد الكتب وعدد الطبعات من الأعمال الكاملة أو حتى الترجمات بما فيها البنغالية.
ما زال يحيى يطلق الرصاصات من "فرده القديم" من شبّاك "مقعده"، بعدما تزوّج فتاة صغيرة، ويخاف من أشباح الخيانة، كبطل قصّته الجميلة، يطلق رصاصته حتى على خيانة مُتخيَّلة، ثمّ يغلق الشبّاك ويعود إلى عروسه.
كان يحيى قلقاً ويعيش قلقه حقيقة من دون أن يطمئن لشيء، سوى صحبة البسطاء والبلديات في السيّدة زينب، أو أصدقاء بسطاء في امبابة أو بشتيل، أو اللجوء إلى محطة مصر بعد أنصاف الليالي كي يحكي مع الصعايدة البسطاء المسافرين، بمقاطفهم وأكياسهم وعمائمهم وحكاياتهم.
الحكاية جنون يمسّ صاحبها، وتظلّ معه تخاتله وتأخذه إلى أماكن غريبة. هل كان يحيى غريباً؟ بالتأكيد نعم، وإلا لما استمرّ إلى الآن أمامنا، وفي كلّ إبريل نحاول أن نراه بشكل مختلف، من دون أن نصل إلى نتيجة أو حلّ.
كان يحيى بجنونه يدرك اللعبة جيّداً، لعبة العيش والكتابة، ويصهر الاثنين في معادلة واحدة ومدهشة، من دون أن يقول للحياة: "هذه هي الحياة"، ومن دون أن يقول لنفسه أو للعالم: "هذه هي الكتابة"، وكأنه يجهل الاثنين معاً، فمسك الاثنين في جنون ونباهة، ولم ينافسه فيهما معاً من جيله أي أحد.
في إبريل نتذكّر الجنون الذي دخل الكتابة بكامل الكرم، فكان هو؛ يحيى الطاهر عبد الله، الذي لا تستطيع أبداً ألا تمسك له أي مقدّمة في قصّة، أو بداية، أو نهاية.
كان يحيى كلغز، مثل قصصه تماماً، ومثل موته في 9 إبريل/ نيسان 1981.

.png)
 منذ ٢ أيام
٣٤
منذ ٢ أيام
٣٤






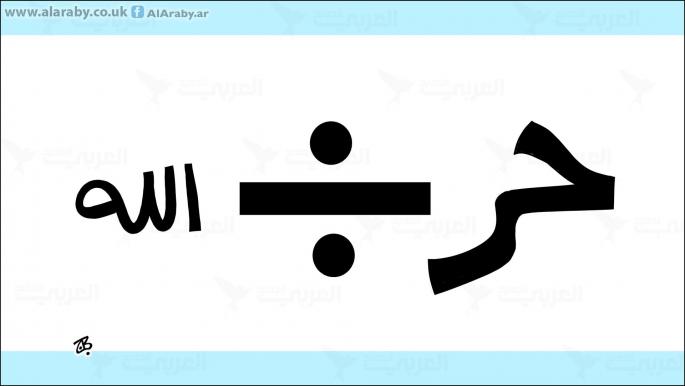

 English (US) ·
English (US) ·