يعيش قطاع غزّة في هذه الحرب/ العدوان المسعورة ويلاتٍ لا حصر لها، ليس على صعيد الإبادة الجماعية والقتل فقط، التي يمارسها جيش الاحتلال ليلًا نهارًا، بل هناك مآسٍ لا تعدُّ ولا تُحصى على الصعيد الإنساني لا تُظهرها عدسات الكاميرا، ولا تسمعها من مراسلي القنوات الإخبارية، ففي كلّ يومٍ في قطاع غزّة مأساةٌ جديدةٌ، فأهل القطاع لا يعيشون أيامهم حقًا بقدر ما ينجون منها، نظرًا إلى الصعوبات البالغة التي يحملونها على ظهورهم، ويتجلّى ذلك في متطلبات النجاة والبقاء على قيد الحياة الصعبة حدّ القصف، والقاتلة حدّ الشظايا، ومستلزماتها التي تأتي بولادةٍ قيصريةٍ، إذ على الغزيين في كلّ يومٍ توفير الماء حالما يستيقظون من مصادرها البعيدة، كما عليهم الوقوف لساعاتٍ في طوابير الخبز، ثم البحث عن آليةٍ ما لإطعام أسرهم، هذا إن حالفهم الحظ ووجدوها، إذ لم يعد هناك أشغالٌ أو أعمالٌ كما كان عليه الحال قبل الحرب.
كل شيءٍ تغير في هذه المساحة الجغرافية الصغيرة، ولم يعد هناك شيءٌ على حاله، فقد تبدلت الأحوال وانقلبت الأمور رأسًا على عقب، فمَن كان لديه بيتٌ يأويه من برد الشتاء، وجد نفسه الآن في خيمةٍ لا تقوى على الوقوف ساعةً في وجه المطر والرياح، ومن كان لديه مصدر رزقٍ يرتكز عليه وجد نفسه عاطلاً عن العمل، ومن كان لديه مبلغ من المال يدّخره ليومه الأسود، نضب ماله ولم تنته أيام العدوان السوداء بعد، فقد طال العدوان وطالت أيّامه ولم يعد في جيب الغزيين سوى الحسرة والألم.
أينما وقعت عينك في قطاع غزّة تجد مأساةً أخرى، ولو دخلتَ كلّ خيمةٍ من خيام النازحين في أي مخيمٍ تشاء، فربما تنهار من وقع ما تسمعه
"هذا ما أورثتنا إياه الحرب، شظيتين في كلّ ساقٍ كانتا كفيلتين ببتر قدميه الاثنتين" يقول خالد، وهو ابن مذبحةٍ نجا منها بعد أن فقد ثلاثةً من أطفاله، وكلّ أخوته، بالإضافة إلى والده، هذا الرجل الذي كان يعمل مهندس ديكور قبل الحرب/ العدوان، أصبح الآن مقعدًا على كرسيٍّ متحركٍ؛ لكنّه بدل أن يستخدمه للتنقل، كما يفعل كلّ المُقعدين حول العالم، يؤجر كرسيّه للناس في المخيم الذي يعيش فيه، كي يضعوا عليه الأشياء ومن ثم يجرونه بدلًا من حملها على بالأيدي والأكتاف، فمثلاً يحمل الناس أكياس الطحين وغالونات الماء على هذا الكرسي المسكين، بعد أن يدفعوا ثمن إيجاره، لبرهةٍ من الزمن، ما يوفر لخالد مصدر رزقٍ، يلبي بعضًا من حاجات مَن تبقّى مِن أسرته، بدلًا من التسول في الطرقات، فهو رجلٌ عزيز النفس، تأبى نفسه طلب المساعدة من الآخرين.
من ناحيةٍ أخرى، تجوب الطفلة زينب، وهي فتاةٌ لا يتجاوز عمرها عشر سنوات، الشوارع كلّ يومٍ إلى أن تتهالك قدماها الصغيرتان، ماسكةً بيدها لُفافات من الترمس، كي تعيل أسرتها المكونة من أمها وأخوتها الصغار، فأمها تعدُّ الترمس في خيمتهم الواقعة في وسط خانيونس بالقرب من مجمع ناصر الطبي، ومن ثمّ تأخذه زينب وتحاول جاهدةً بيعه للمارة في الطرقات، تضيف زينب: أنّ هذه المهنة هي طوق النجاة لعائلتها لأنها تؤمن قوتَ يومهم، بعد أن فقدت العائلة ربّ أسرتها، وهي لا تعلم إن كان والدها حيًا أم ميتًا، فبينما نزحتْ هي وأمها وأخوتها الصغار إلى الجنوب، بقي أبوها هناك في شمال غزّة، كما أنّ ما تجنيه من بيع حبات الترمس تلك، على مدار عامٍ وأكثر حتّى الآن، هو السبيل الوحيد للخروج من مأزق الحياة بعد أن تشتتت عائلتها، وهو ما ساعدها على توفير الحليب والخبز لإخوتها الصغار طوالَ فترة الحرب.
كلّ هذه المآسي غيضٌ من فيض، فأينما وقعت عينك في قطاع غزّة تجد مأساةً أخرى، ولو دخلتَ كلّ خيمةٍ من خيام النازحين في أي مخيمٍ تشاء، فربما تنهار من وقع ما تسمعه، غيرَ أن هؤلاء الأناس رزقهم الله قدرةً غريبة على مصادقة جروحهم، ومصاحبة آلامهم، ونفخ في أرواحهم ما نفخ من تحدٍّ وصمود، حتى باتوا يلوّنون الحياة الرمادية بما تيسّر في أيديهم من آمال.

.png)
 منذ ٢ شهور
٤٣
منذ ٢ شهور
٤٣






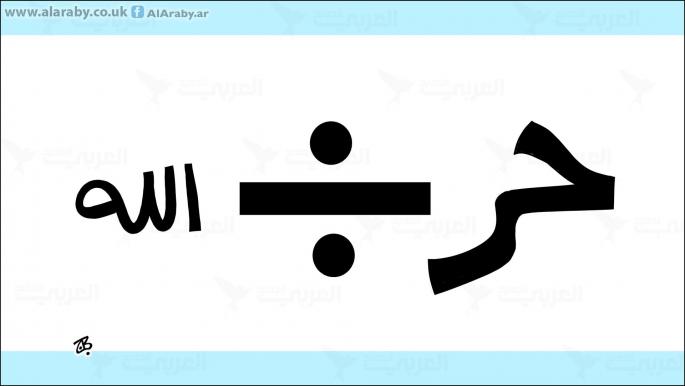

 English (US) ·
English (US) ·